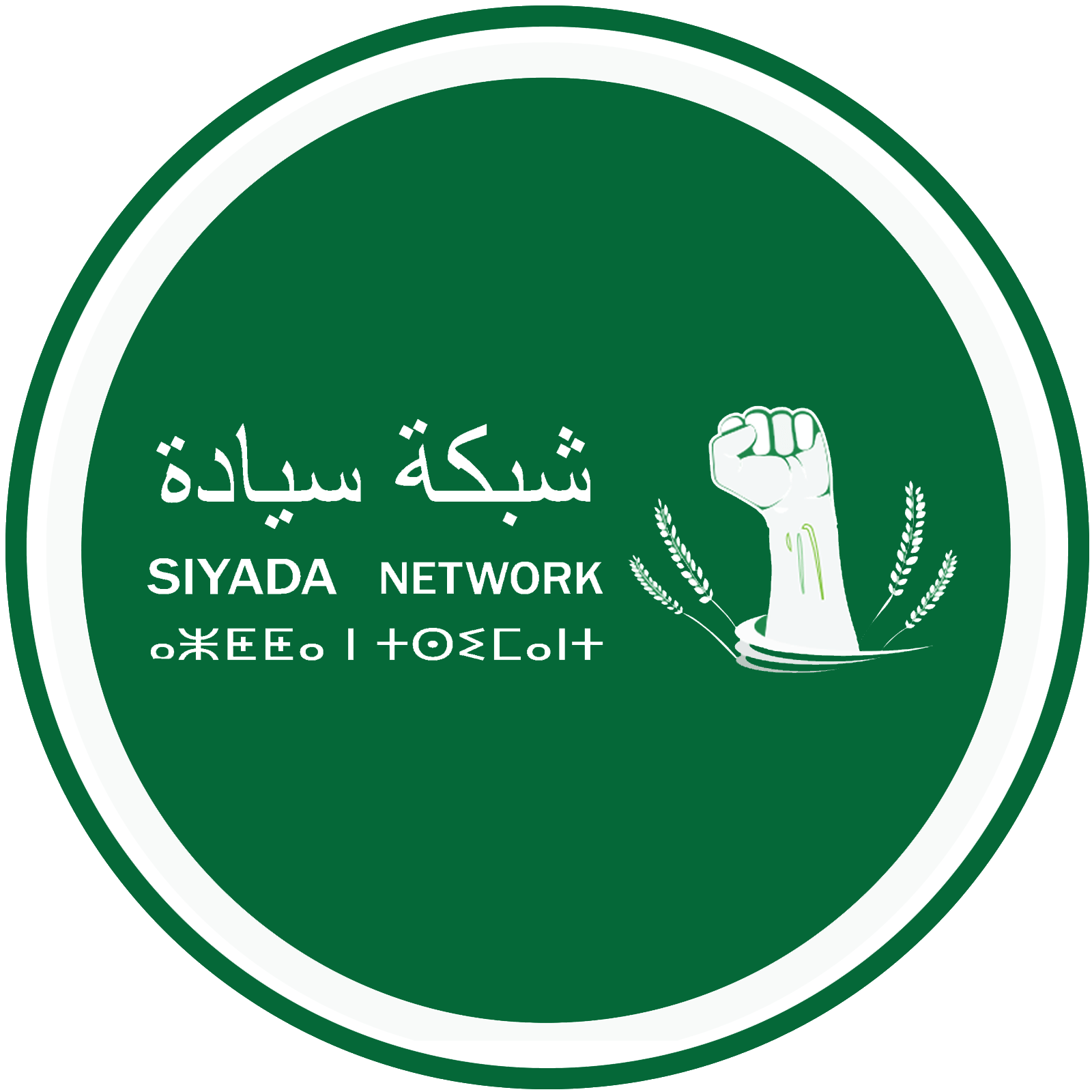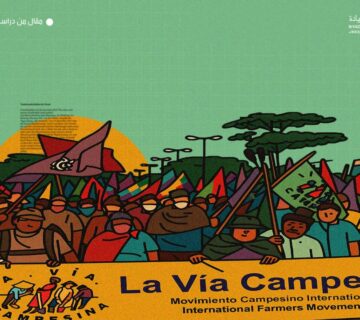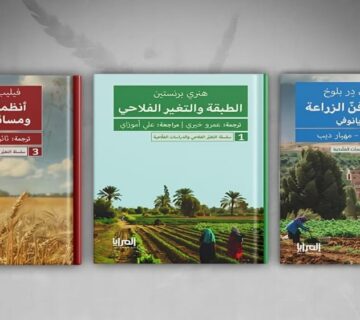وقفت إلى جانب عم الهادي في أحد حقول النعناع الواقعة على أطراف مدينة غنوش الممتدة على خليج قابس، وهي الأرض التي استصلحها بيده قبل أكثر من ثلاثين عامًا. أرض غير مهيكلة تبلغ مساحتها 1490 هكتار و 420 هكتار سَبخة كانت الدولة قد صنّفتها على أنها غير صالحة للزراعة[1] أو الرعي، ولكن مع صغر مساحة المعتمدية مقارنة بعدد السكّان و مع تزايد نسبة الفقر والحاجة بين العروشات (القبائل) قام عرشان: «رحايمة» و«علاية» بالتّوسّع على حساب الأراضي الدوليّة بمنطقة العوينات 1 و2 واقتسامها فيما بينها على شكل مقاسم عام 1991[2]، وشرعوا بتهيئتها باعتماد تقنيات بدائية (قاموا بحفر خنادق محاذية للأرض لتجفيف التربة وقاموا بتغطية السبخات بطبقة أخرى من التربة تكون رملية من ثم زراعة محاصيل تتحمل ارتفاع الملوحة مثل الخضروات الورقية )، وتوزيع المقاسم وفصلها عن بعضها البعض باستخدام الطوابي وحفر الٱبار ليلًا. هكذا حدثني عم الهادي: «يجي الحاكم الصباح يلـڨـا كان الطوابي».

لم يستسلم الفلاحون على الرغم من الإيقافات وردم آبارهم، وواصلوا عملية الاستصلاح إلى أن تحولت من سبخة مهملة إلى جَنّة مُنتِجة لكل أنواع الخضراوات والورقيات التي تغطي حاجيات المنطقة، إذ تساهم بما يقارب من 70% من الإنتاج الفلاحي بولاية قابس[3]،و تعيش منها اليوم حوالي ال 300 عائلة وتوفر مواطن شغل لعديد من العمال[4] ،بل ونجح عم الهادي في زراعة القمح والشعير من البذور الأصيلة، وذلك في ظل هيمنة البذور المستوردة، لتُكافئ الدولة في الأخير مجهودات هؤلاء الفلاحين بتكييفهم على أنهم مغتصبو أراضٍ دولية!
كان الطقس حارًّا، لكن رائحة النعناع تنعش الجو، رائحة قد تمتزج في أي لحظة بدخان سيارات الشرطة التي تقتحم المكان من وقت لآخر لتنفيذ قرارات الإخلاء.
لا يعلم عم الهادي إن كان هذا الصباح قد يكون الأخير الذي يقضيه فيه أرضه قبل طرده بالقوة، ففي عينيه المتوقدتين سنوات مديدة من الكدح، وفي ذهنه صورة لأوراق محاكم تحمل أختام الدولة، وفيما بينهما تتجسد مسألة أعمق من مجرد نزاع عقاري عادي، صراع تمتد جذوره عبر التاريخ، ألا وهو الصراع على ملكية الأراضي الفلاحية.

فمنْ يحق له أن يملك هذه الأرض؟ الدولة التي تركتها مرتعًا للخنازير البرية لاستقطاب السُّياح الأجانب الباحثين عن الصيد الترفيهي، أم الفلاحون الذين رأوا فيها إمكانية لإعادة الحياة إليها وخطوة لبداية تحقيق السيادة الغذائية؟.. «من الأولى أني وإلا الخنزير؟» هكذا لخص عم الهادي فلسفته البسيطة والعميقة في نفس الوقت.
ملكية الأراضي الفلاحية كأداة هيمنة
لا يمكن أن نفهم جذور المشكل من دون الرجوع إلى فكرة تكوُّن الخزّان العقاري الدولي. لقد صاحب الاستقلال نمو الرصيد العقاري للدولة المتأتي من مصادر مختلفة، منها الأحباس العامة أي الأوقاف التي كانت مُسخَّرة للأعمال الخيرية، وكذلك الأراضي المنتزعة من العائلة الحسينية، وأخرى بفعل المحاكمات التي طالت المخزَّن الأعلى بداية الاستقلال، وأراضي المُعمرِين الذين تخلوا عنها غداة الاستقلال والتي عادت للدولة قبل الجلاء الزراعي، والأراضي التي تسلمتها الدولة عند مغادرة الجيوش الفرنسية لبنزرت سنة 1963، والأراضي التي تم استرجاع ملكيتها سنة 1964.
وعلى الرغم من تعدد مصادر محفظة الأراضي الدولية، فقد كان أغلبها أراضيَ يتملكها فلاحون بالأساس، وانتُزعت منهم في وقت ما تحت حكم البايات الحسينيين (البايات العثمانيين الذين حكموا «الإيالة التونسية» وكانوا روّادًا في نزع الأراضي في أواخر القرن السادس عشر، حين بدأت مسيرة ضمّ الأراضي المنزوعة إما لبيت المال أو لأملاك الحاكم مباشرة[5])، واستمر سلب الأراضي فيما بعد من طرف المستعمر الفرنسي لتعود ملكيتها إلى دولة الاستقلال في نهاية المطاف.
سعت الدولة منذ عقود إلى تجميع الأراضي بحجة تفادي تشتُّت الملكية، وهو إشكال حقيقي في بعض الحالات إلا أنه جزئي، لكن هذا السياق التاريخي سيُشكِّل مُحددًا رئيسيًّا لعلاقة دولة ما بعد الاستقلال بالأهالي الأصليين وسياساتها الزراعية فيما بعد.
منذ المراحل الأولى لمغادرة الفرنسيين، بدأت بعض أملاك الأجانب تتوزع على الموالين والأقرباء، ولاسترضاء البعض الآخر أو محاولة تطويعهم، وفي هذا الصدد يندرج خطاب افتتاح المجلس المحلي للحزب الدستوري بالمنستير يوم 2 مارس 1963 عندما صرّح الحبيب بورقـيبة عند الحديث عن رخص النقل والأراضي الدولية: «وقد رأينا لتعقُّد المُشكِل أن نبيعها إلى أناس راعينا أن يكونوا دستوريين».
ولعل تأميم الأراضي سنة 1964 قد شكل الغنيمة والمناسبة الكبرى للتوسع في الإهداء و«رد الجميل» للمناضلين والمقاومين (المساندين للخط البورقيبي) ولغيرهم، ولمجازاة الكثيرين على أعمال جليلة قاموا بها (أو يُفترض رسميًّا ذلك). ففي شهادة وردت في محاضرة سلوى الخياري بمنتدى التميمي ليوم 4 أفريل 2015، ذكر محمد بالحاج عمر (السياسي المعارض و القيادي السابق في الوحدة الشعبية) بعض الأمثلة، منها حصول عبد العزيز الوردني وعدد من مقاومي الوردانين على مقاطع بجهة ماطر في عهد الحبيب بورقيبة، كما تَحصَّل مقاومو طبلبة بمقاطع في جهة الحبيبة، وتوسعت العطاءات لتشمل أناسًا غير متوقعين، فقد قدَّم في الجلسة نفسها محمد بالحاج، والي جندوبة لفترة 1988ـ1990، شهادةً ذكر فيها وجود 13 ملف تمليك للأراضي الدولية، من بينها ملف اسم صاحبته «شامة» إحدى خادمات وسيلة (زوجة بورقيبة).
وتندرج العطاءات العقارية في تقاطع ثلاث ظواهر، وهي تباعًا: زبونية الدولة، والتملُّك بها، وثقافة البلاط.
تغيرت في عهد بن علي الصيغة القانونية للتصرُّف في الأراضي الدولية، ووضعت 300 ألف هكتار منها على ذمة شركات إحياء، وتمت مراجعة معادلة التبادل الزبوني مع الدولة. ويكمن الفرق في ضمان تواصل الولاء للسلطة عبر التسويغ، مقابل معلوم رمزي عِوضًا عن التمليك، فالمتسوغ مطالب بتجديد الولاء باستمرار، ليس كالمتملك الذي قد يتغير مزاجه لاحقًا. وبداية من سنة 1991 أصبحت ظروف التوزيع غامضة وغدت تعتريها الشبهات[6].
الشركات الأهلية وإعادة إنتاج نظام السيطرة على الأراضي
هكذا تحولت الأرض إلى أداة بيد السلطة تستخدمها إما لخلق زبونية للنظام الحاكم، أو لمعاقبة معارضيها بحرمانهم منها، وحتى الآن تواصلت هذه السياسة من خلال فكرة الشركات الأهلية التي أصدرها الرئيس الحالي قيس سعيد في شكل مرسوم ودخلت حيز التطبيق في مارس 2022.
ووفقًا للمرسوم المُحدَّث لها، فإن هذه السياسة تضرب مبدأ استقلالية الفلاحين الراغبين في الانتظام في تعاونيات فلاحية، بما أنها تخضع للإشراف المباشر للدولة عبر موظفيها الجهويين والمحليين الذين لهم الحق في اتخاذ قرار حل أي شركة متى توفرت الشروط القانونية، ويشرفون على الجلسات التأسيسية للشركات الأهلية ومراقبة المساهمين في تطبيق قواعدها.
إذن فالشركات الأهلية تصادر تنوع أشكال التنظيم بين الفلاحين والذي هو أمر أساسي وحيوي في عملية الإنتاج، كما تقمع ثقافة التضامني الجماعي في حد ذاته المبني على مسألة الاستقلالية التي تساهم في تحقيق الثروة وإعادة الإنتاج، وبالتالي هي ليس ذلك القمع سوى آلية من بين الآليات التي تسعى إلى إبقاء الخزان العقاري تحت سلطة الدولة وتوجيه الناس بصفة عمودية بقرار مُنزَّل من صاحب السلطة الذي يوزع النفاذ للأرض على حسب احتياجاته السياسية، ويعيد إنتاج نفس نظام التحكم في الأراضي الدولية وحتى الاشتراكية.
وليس مُستبعدًا أن نجد أعضاء مجالس محلية مساهمين في شركات أهلية، فتتداخل بذلك المصالح الاقتصادية والسياسية، بما يخلق نخبة اقتصادية جديدة محتملة ملتفة حول السلطة.

وهكذا تحولت الأرض، كأهم عناصر الإنتاج الثلاث وأولها في تاريخ النشاط الاقتصادي البشري، إلى جانب العمل ورأس المال، إلى رمز للسلطة ووسيلة لضمان استمراريتها، فمن يملك وسائل الإنتاج يملك السلطة والقدرة على تحديد مصير الآخرين وعلى رسم خريطة العلاقات الاجتماعية والسياسية.
تعطيل مُمنهج: كيف تُسَد طرق النفاذ إلى الأرض أمام منتجي الغذاء الحقيقيين
بالتالي تَعطُّل نفاذ منتجي الغذاء الحقيقيين في تونس (صغار ومتوسطي الفلاحين، مزارعون دون أرض، عاملات فلاحيات) إلى وسيلة الإنتاج الأساسية في نشاطهم يزيد وضعيتهم سوءًا، باعتبار أن ضمان وصولهم إلى الأرض بصفة تعاقدية مستمرة يُمكِّنهم من الانخراط في العملية الإنتاجية على المدى الطويل عِوَضَ إبقائهم في حالة هشاشة من خلال موسمية توظيفهم وتحولهم إلى عمال مأجورين (في أراضي أجدادهم وقبائلهم) ويقع امتصاص فائض قيمة عملهم من قِبَل ملاك وسائل الإنتاج الذين يرمون لهم بالحد الأدنى الذي يبقيهم على قيد الحياة من أجل الاستمرار في الإنتاج، أو اضطرارهم للنزوح إلى المدن والعمل في قطاعات أكثر هشاشة (البناء، الدهان، المصانع…) بلا ضمانات استمرار أو تطور.[7]
ويجدر بنا التأكيد على أن من بين أسباب فقدان التوازن الديمغرافي في تونس وإفراغ الأرياف من سكانها، استحواذ المستعمر ثم الدولة على الأراضي الفلاحية الأكثر خصوبة وإنتاجية التي يتواجد أغلبها بالمناطق الرطبة وشبه الرطبة، مما يعيد إنتاج التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والجهوية، كما أن النزوح الجماعي تسبب في تفكيك البُنى القبلية والعائلية الموسعة التي كانت تستغل وتدير الأراضي ذات الملكية المشتركة[8].
إذن كل نظام سياسي يأتي على تونس يبحث عن آلية مختلفة لإبقاء سيطرته على هذا الخزّان العقاري الخصب، لإحكام سلطته المفتقرة إلى الشرعية الديمقراطية، ومنه محاولته للبحث عن حلول للتحكم في الأرياف و«بولستها»، والحل هو خلق موالين لها عبر التحكم بهذه الأراضي ليعودوا إليها في النهاية.
ولعل رفض الدولة لتسوية الوضعية القانونية لفلاحي غنوش رغم تعبيرهم المستمر عن استعدادهم لذلك (التسويغ، النفاذ، التفويت) وإعطائها الأولوية للمستثمرين الخواص أو التقنيين والمهندسين من خريجي مدارس الفلاحة، أي الذين يمتلكون الكثير من المال و/أو المعرفة (وسط وهم تعالي المعرفة الأكاديمية على المعرفة المحلية) خير دليل على أن تصرفها في هذه العقارات لا يندرج البتّة ضمن رؤية اقتصادية وتنموية بل في كيفية بناء تحالفات سياسية حول محيط السلطة الحاكمة.
أخيرًا، الدولة من خلال سيطرتها على الأرض لا تمارس فقط سلطة اقتصادية بل تفرض أيضًا رؤية معينة للعالم تجعل من سلطتها أمرًا طبيعيًّا ومشروعًا، إذ يصبح القانون الذي يُكيِّف هؤلاء الفلاحين كمغتصبي أراضٍ أو معتدين، أداة لتكريس هذه الهيمنة، بينما يتم تجاهل الشرعية التاريخية وحق التملُّك بالنسبة للمجتمعات المحلية.
الملكية والهُويّة
أغلب هذه الأراضي كانت أراضي جماعية تملكها القبائل والمجتمعات المحلية، لكن عمليات المسح والتسجيل التي جرت في العهد الاستعماري وما بعده تجاهلت هذا الواقع وأدرجتها ضمن أملاك الدولة، وهو ما يُظهر بوضوح فيما يُسمى بالتاريخ من الأسفل، فالتاريخ الرسمي كما تحكيه الوثائق الحكومية والقوانين يختلف جذريًّا عن التاريخ كما يعيشه الناس، فهؤلاء الفلاحون يحملون في ذاكرتهم تاريخًا مختلفًا عن التاريخ الرسمي الذي يروي قصة الأرض من منظور منْ يعمل ويعيش عليها.
هذه الذاكرة تشكُّل الأرشيف الشفهي البديل للأرشيف الرسمي والتي تضم مجموعة الحكايات والشهادات والتقاليد التي تنتقل من جيل إلى آخر وتحافظ على السردية البديلة للأحداث.
بالنسبة لعم الهادي ورفاقه، حقهم في الأرض لا يأتي من ورقة رسمية بل من أحقيتهم التاريخية لها ومن عقود من العمل والاستصلاح، إنه حق مكتسب بالعرق والدم، «ما عنديش وثيقة ندافع بيها على أرضي.. عندي كان دمي» هكذا أكّد لي عم الهادي!
هذا حق متجذر في الذاكرة الجماعية للمجتمعات الريفية، وهنا يكمن البُعد الأنثروبولوجي العميق للعلاقة بين الإنسان والأرض، حيث يُفيد علم التأثيل (Etymology)[9] أن أصل كلمة أرض باللغة العربية يعود إلى اللغة الأكدية، أقدم لغات بابل (erṣetu) والتي تعني العالم السفلي المقابل للسماءـ وتعني جزءًا من الكبد في الآن ذاته، هذا التداخل الدلالي القديم بين الأرض والكبد، مركز العواطف في الفكر الرافديني، يُفسر لماذا تصبح السيطرة على الأرض بمثابة انتزاع لجزء من الجسد، أو يمكن أن يُفسر كذلك للدلالة على الأرض كـ «قطعة من الكبد» أي أغلى ما يملك الإنسان، استنادًا إلى الاعتقاد القديم بأن الكبد مركز العواطف والمشاعر.
وفي الحالتين تتجاوز مسألة الأرض في الثقافة الريفية التونسية كونها مجرد أداة إنتاج، بل هي جزء من الهُويّة الجماعية للمجتمع ومساحة رمزية محملة بالمعاني، والسيطرة عليها تعني إذن السيطرة على الذاكرة والهُويّة، وهذا ما يُفسر الطابع العاطفي والرمزي للمقاومة التي يُبديها الفلاحون.
فلسفة المقاومة: عندما تصبح الفِلاحة فعلًا سياسيًّا
المقاومة ليست مجرد رد فعل على السلطة، بل هي جزءًا لا يتجزأ من نسيج السلطة ذاتها، وهي تُولَد في اللحظة ذاتها التي تُولَد فيها محاولة الهيمنة، وفي الحقول التونسية تتجسد هذه المقاومة في أبسط الأفعال اليومية: حراثة الأرض، بذر البذور، جني الثمار… كل فعل من هذه الأفعال يحمل في طياته تحديًا صامتًا للسلطة، فعندما يزرع عم الهادي البصل في أرض تعتبرها الدولة ملكها، هو لا يزرع مجرد خضار، بل يزرع بذور الاعتراض، وكأنه يقول: «هذه أرضي وباش نوريهم لي هي أرضي بعرڨـي موش بالأوراق».
هذا النوع من المقاومة اليومية لفلاحي غنوش يدخل في اللاحراكات الاجتماعية non social movements، وهي تلك الأشكال الخفية من التمرد التي لا تتخذ شكل الثورة المباشرة لكنها تُقوِّض أسس النظام من الداخل، وتشمل الأنشطة الجماعية التي يقوم بها فاعلون غير جمعيين دون اتفاق فيم بينهم بدون قيادات أو منظمات معروفة.

هؤلاء الفاعلون يعملون بصورة تلقائية ويبدأ تحركهم برد فعل فردي يتسم بالعفوية في تعاطيه مع معطيات الواقع، وترتكز هذه الديناميكية على العدد، فقوة تأثير اللاحركات الاجتماعية ترتبط بتآلف سلوك أعداد كبيرة من البشر، الذين لا يوجد اتفاق فيما بينهم، بمجموعة من الأنشطة والسلوكيات التي تكتسب نمطًا معينًا بمرور الزمن والتي تهدف للحصول على الضروريات الأساسية للحياة، وعادة ما يصاحب القيام بهذه الأنشطة مخالفة «هادئة» للقانون، أي لا ينطوي على استخدام أدوات العنف ويستمد شرعيته من جماعية السلوك لعدد كبير من البشر.
فهي مقاومة بلا قادة ولا برامج سياسية، لكنها تملك قوة تراكمية هائلة، مقاومة تحمل في طياتها أبعادًا متعددة: فهي أولًا فعل اقتصادي يهدف إلى ضمان استمرار الإنتاج والدخل، وهو ثانيًا فعل اجتماعي يهدف إلى الحفاظ على التماسك المجتمعي في المناطق الريفية، وهو ثالثًا فعل ثقافي يهدف إلى الحفاظ على الهُويّة والتقاليد الزراعية والممارسات المحلية، لكن الأهم من ذلك أنه فعل سياسي يتحدى توزيع السلطة في المجتمع.
وعندما حوَّل عم الهادي السَّبخة إلى أرض مُنتِجة، فإنه لم يُثبت فقط قدرته على الإنتاج، بل أثبت أيضًا فشل التصنيف الرسمي للأرض كـ «غير صالحة»، وأثبت أن المعرفة البيروقراطية المجردة لا تضاهي المعرفة المحلية المتجذرة في التجربة الحيّة؛ هذا ما يُسمّى في الأنثروبولوجيا بـ «المعرفة المَوْقِعيّة» أي المعرفة التي تنبع من التجربة المباشرة مع المكان والزمان، مقابل المعرفة المجردة التي تُنتجها البيروقراطية من مكاتبها المكيفة.
الأرض لمن يستصلحها: من فلسفة لوك إلى واقع الفلاحين في غنوش
تؤسس مقولة جون لوك «الأرض لمن يستصلحها» لمفهوم الملكية القائم على الجدارة والإنتاجية بدلًا من الوراثة أو القوة. في حالة عم الهادي، هذه الفلسفة تُبرر أحقيته في الأرض التي يخدمها، لأن عمله هو الذي يُضفي عليها قيمتها الحقيقية ويجعلها مفيدة للمجتمع.
تطبيق هذه الفلسفة في سياقنا يتطلب إعادة النظر في دور الدولة كمالك للأراضي الفلاحية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مشروعية هذه الملكية، خاصة في حالة إهمالها أو استغلالها من قِبَل مستثمرين مخالفين لكراس الشروط ولا يوفون بديونهم للدولة، ويدعو إلى إصلاح هيكلي حقيقي يُعيد توزيع الأراضي لصالح من يستغلونها فعليًّا، لأن استمرار هذا الوضع يعني تكريس نموذج إقطاعي جديد تحل فيه الدولة محل الإقطاعي التقليدي، مما يتناقض مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي لا تتحقق إلا حين يصبح الفلاح مالكًا لأرضه وليس مجرد عامل فيها، سواء أكانت الأرض مُستغلة مباشرة من الدولة، أم تحت يد مستثمرين يهدفون إلى إنتاج محاصيل أُحادية مخصصة للتصدير مُستنزِفة للموارد، على عكس صغار الفلاحين الذين يميلون إلى التركيز على إنتاج الغذاء الذي يُباع في الأسواق المحلية والوطنية ويصل إلى الأشخاص الذين هم في أَمَسِّ الحاجة إليه.
هذا ما يدعونا إلى إعادة التفكير في مفهوم الملكية، فبدلًا من النظر إلى الأرض كسلعة يمكن بيعها وشراؤها، علينا النظر إليها كموروث جماعي يجب الحفاظ عليه، وبدلًا من التركيز على حقوق الملكية الفردية يمكننا التفكير في حقوق الاستخدام الجماعي.
الطريق من الهامش إلى المركز: التنظّم ضروري
في النهاية، لا بد أن ننظر إلى القضية الفلاحية كجزء من نظام سياسي اجتماعي أشمل، لا كظاهرة منفصلة أو مستقلة بنفسها، فعم الهادي وجيرانه، العاملات الفلاحيات وكل الفلاحين بلا أرض، مجموعة في غليان مستمر، لكنهم غير قادرين على إنتاج تعبير مُمركز لطموحاتهم واحتياجاتهم، فبدون إطار تنظيمي ستبقى حركات الطبقات التابعة مُعرّضة لخطر التحوُّل إلى اهتزاز فوضوي، أو أن يتم امتصاصها من جديد ضمن البُنى المهيمنة السائدة. (الدليل على ذلك أن أغلب تجارب الاستيلاء على أراضي الدولة بعد 2011 بقيت فردية وغير منظمة، مما أدى شيئًا فشيئًا إلى أفولها). وهنا يأتي دورنا كمناصرين للقضايا العادلة في احتوائهم وتأطيرهم.

أنا شخصيًّا، لم أفهم يومًا التوجه السائد للجمعيات التي تسعى إلى تحسين ظروف نقل العمالة الفلاحية وحسب، ولا تبحث في طرق نفاذ العمال إلى الأرض، وكأننا مطالبون بتحسين ظروف عبوديتهم فقط بتوفير نقل أفضل حالًا من ذلك. لعل هذه الرؤية الضيقة في معالجة المشاكل الهيكلية هو ما يُفسر قصور المنظمات والأحزاب في تعبئة الأغلبية الفلاحية حول برنامج جذري.
في الواقع، وظيفتنا تذهب إلى أبعد من ذلك، إذ تتمثل في كشف تلك التعقيدات وترجمة حركتها إلى لغة نظرية، والبحث عن بدايات أخذ المبادرة وتكوُّن الهُويّة الطبقية لدى المهمشين وتغذيتها وتثقيفها وتطويرها لتصبح وعيًا طبقيًّا وعملًا سياسيًّا فعّالًا، فالوعي الطبقي لا يمكن أن يَتشكَّل إلا من داخل الجماعة، لا يمكن فرضه بقوة من الخارج[10].
لذا فإن واجبنا دراسة العواطف العفوية والبدائية لعم الهادي وفلاحي غنوش الرافضين للتخلي عن أراضيهم برغم قرارات الإخلاء والهرسلة (المضايقات) الأمنية المستمرة، ومقاومتهم اليومية من خلال عملهم لا تجاهلها، وتطويرها لا احتقارها، وتعميق الوعي الطبقي لدى القوى الفلاحية بشكل عام، والإيمان بإمكانية تحولهم إلى طبقة ثورية قادرة على حفر مجال سياسي مستقل لهم ضمن بُنى السيطرة الكبرى.
وعلى حد تعبير محمود درويش: «الأرض والفلاح والإصرار، هذه الأقانيم الثلاثة، قُل لي كيف تُقهر؟!»
ففي كل بذرة يزرعها عم الهادي، في كل قطرة عرق تسقط على الأرض، في كل صباح يستيقظ فيه ليواجه التحدي، تتجسد المقاومة كفعل إيمان، كفعل أمل في مستقبل أفضل.
ندى الهمّامي – تونس
هوامش
[1] نظرا لارتفاع نسبة ملوحتها (هي أرض مستوية، عادة ما تقع بين صحراء ومحيط أو كانت فيما سبق بحيرة أو بحيرة ملحية، ويتميز سطحها بوجود ترسبات ملحيّة وجبسية وترسبات كربونات الكالسيوم وكذلك رواسب جلبتها الرياح والمد المائيّ، وقد تحوي على الماء)
[2] حسب ما أفادني به عم الهادي
[3] وفق معطيات مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية لموقع انحياز (فيديو قابس فلاحو غنوش مهددون بالطرد من الأراضي التي استصلحوها)
[4] ،( من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها مجموعة العمل من اجل السيادة الغذائية الي الأراضي الفلاحية التي يستغلاها فلاحي غنوش نلاحظ ما توفره من يد عاملة فلاحية إذ تشغل 300 ألف عاملة فلاحية وما يقارب 450 ألف (عمال وعاملات فلاحيين/ت حفر أبار/ تركيب الطاقة الشمسية…) يوم عمل في السنة)
[5] تونس: فلاحون من دون أرض وأراضٍ بلا فلاحين ـ محمد رامي عبد المولى
[6] كتاب الاستعمار الداخلي و التنمية المتكافئة منظومة التهميش في تونس الصغير الصالحي
[7] التراكم الأولي لرأس المال في تونس: القرون الخمس الأخيرة هيثم قاسمي
[8] الفلاحة في تونس في القرن الواحد والعشرين: التحديات والمخاطرـ شبكة سيادة
[9] ملف الأرض أم المعارك، هيثم القاسمي
[10] أنطونيو غرامشي، في الهند