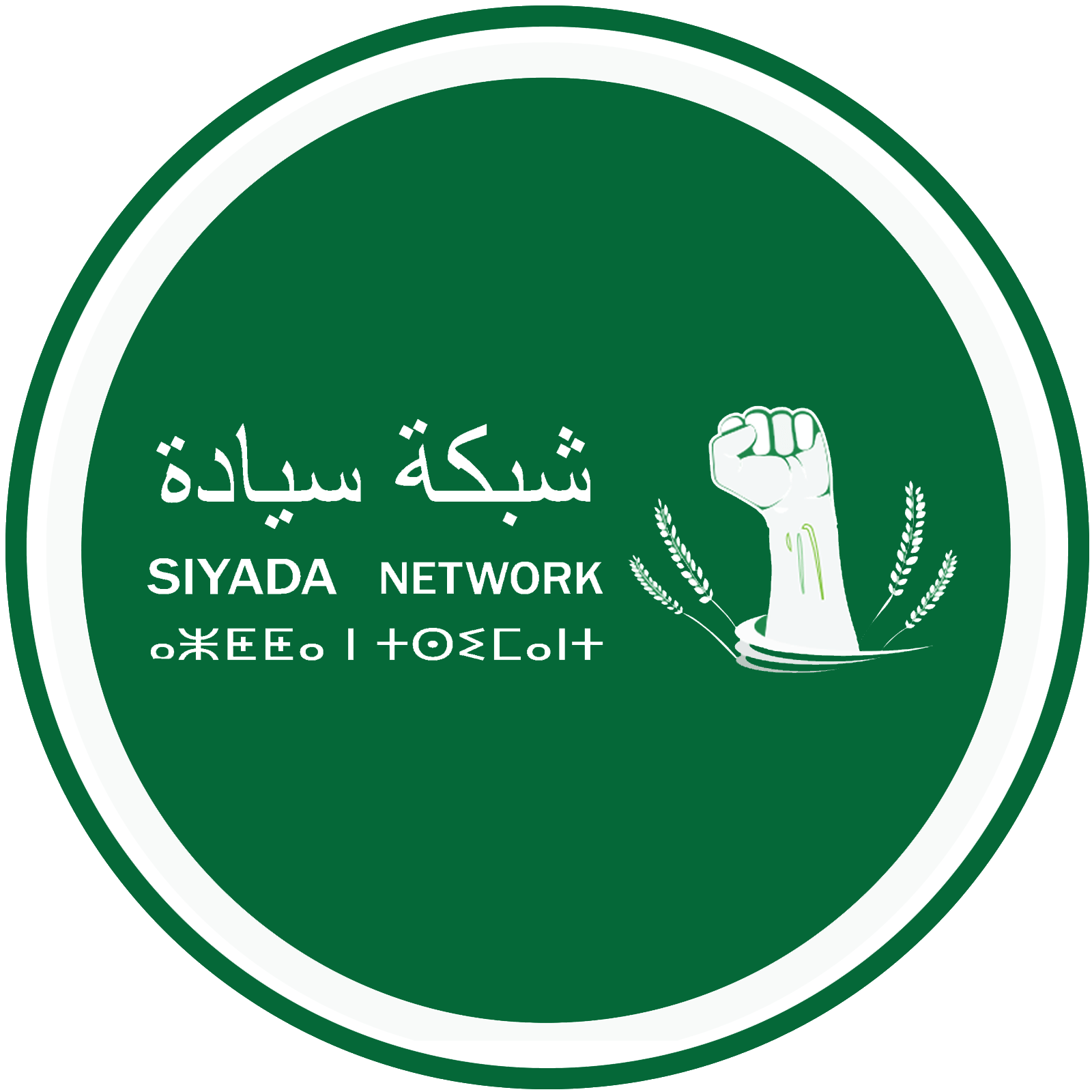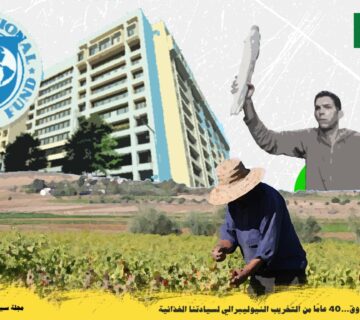في قلب الجنوب الشرقي التونسي، تقف قابس شاهدة على مفارقة حادّة: مدينة تزخر بالتنوّع البيئي والمعرفي، لكنها ترزح تحت وطأة التلوّث الصناعي والتهميش التنموي. على أطرافها، وتحديدًا في منطقة كابانا، التابعة إداريًا لمعتمدية غنوش في ولاية قابس، حيث تتجسّد مقاومة هادئة ولكن عميقة، تقودها جماعات من الفلاحين، والشباب، والناشطين البيئيين، والباحثين، في سعيٍ جماعي لإعادة إحياء الأرض وتحقيق السيادة الغذائية.
قابس مدينة نادرة في جغرافيتها، تجمع بين البحر والواحة والجبل والسبخة. هذا التنوع جعلها مركزًا تاريخيًا للزراعة الواحية المتوازنة والمعتمدة على تعايش النخيل والأشجار المثمرة والخضروات. لكن هذه المنظومة تضررت بفعل التمدد الصناعي منذ سبعينيات القرن الماضي، خاصة بعد انتشار المُجمع الكيميائي، ما أدى إلى تلوث الماء والتربة والبحر، وضرب التوازن البيئي المحلي، والقضاء على عدد من أنشطة الفلاحة والصيد البحري.
مقاومة غير مرئية:
تُطلّ تجربة استصلاح أرض كابانا، التي كانت تُعرف كأرض سبخة، هامشية، فقيرة بيئيًا، ومُهددة بالمضاربة العقارية، لتتحوّل بجهود السكان إلى أرضٍ منتجة، تعبق بالحياة. لقد تمكّن فلاحون محليون، من بينهم شباب جامعيون، من استصلاح الأرض وزراعة أصناف تقليدية ومحلية من الزيتون، التين، الرمان، والخضروات المُقاومة للجفاف، مستخدمين وسائل بسيطة ومستدامة.
في هذه الأرض لا تُمارَس الزراعة فقط بهدف العيش، بل كفعل مقاوم ونقد للنظام الغذائي العالمي. السيادة الغذائية هنا ليست شعارًا، بل ممارسة متجذّرة في التراب، تُعبّر عن رفض التبعية للمنتجات المستوردة، والأسمدة الكيماوية، والبذور المعدّلة. الإنتاج موجه بالأساس للاستهلاك المحلي، وخارج منطق الربح والتسليع.
الفاعلون في هذه التجربة – فلاحون، ناشطون، باحثون، صحفيون – يتقاطعون في نسيج مقاوم، يعيد امتلاك أدوات الإنتاج: الأرض، الماء، والمعرفة. وهنا تظهر أهمية الربط بين الفعل والبحث، حيث لا يكتفي الباحث بالملاحظة، بل يُشارك في بناء بدائل واقعية، متحرّرة من قوالب المؤسسات.
تُنتج هذه الشبكات أيضًا خطابًا نقديًا، يربط الزراعة بالعدالة البيئية، ويرى في الفلاحة الريفية مجالًا للصراع مع منطق السوق ومنطق الرأسمالية الاستخراجية أو استخراج الموارد الطبيعية أو البشرية لتحقيق الربح السريع. وهنا، تتحوّل الفلاحة من نشاط اقتصادي إلى فعل سياسي-ثقافي، يُعيد رسم العلاقة بين الإنسان والطبيعة.
يلعب الباحثون والصحفيون دورًا مساندًا في هذه التجربة، لا بوصفهم مراقبين محايدين، بل كأطراف منخرطة في دعم الفعل الجماعي، عبر توثيق المعارف المحلية، ومرافقة الفلاحين في تحليل وتحسين تقنيات الإنتاج، والمساهمة في إنتاج معرفة ملتزمة ومتحررة من قيود المؤسسات التقليدية. هذه العلاقة التشاركية بين البحث والميدان تفتح أفقًا جديدًا للمعرفة، حيث تتحوّل الجامعة إلى حليف، لا إلى سلطة، وتُبنى الجسور بين العلم الأكاديمي والمعرفة المجتمعية الحية.
وسط هذه الديناميكية، يبرز عمّ الهادي كأحد وجوه المقاومة الريفية في كابانا، التي لم تُسلّط عليها الأضواء الإعلامية أو الأكاديمية. بعزيمته اليومية، وصبره الطويل على الأرض، وسرده الحيّ لذاكرة المكان، يمثّل عمّ الهادي جيلًا من الفلاحين الذين مارسوا السيادة الغذائية قبل أن يُصاغ المفهوم نظريًا. تجربته ليست استثناء، بل مرآة لتجارب كثيرة مماثلة، مُهمّشة لكنها حيوية.
هذا المقال كُتب بصيغة تُجسّد روح المدرسة التي نظمتها شبكة سيادة بتونس، حيث التقى الفلاحون\ات والباحثون\ات والصحفيون\ات والناشطون\ات في مساحة مشتركة لتبادل المعارف، وتجميع الجهود، وتفكيك السرديات السائدة حول الزراعة والتنمية، وهذه الكتابة لا تدّعي الحياد، بل تنخرط في الفعل، وتُشارك في بناء الأفق، لا فقط وصفه.
ذاكرة حيّة للمقاومة:
تجربة كابانا تطرح أسئلة جوهرية: كيف نُعيد الاعتبار للمعرفة الفلاحية؟ كيف نبني فلاحة تستجيب للعدالة المناخية والبيئية؟ كيف نُعيد تشكيل السياسات الفلاحية من الأسفل؟ وهي تجربة هشّة في مواردها، لكنها متينة في جذورها، وتُظهر أن الأرض، حين تسترجعها الأيدي التي تحبّها، تُصبح مجالًا لإنتاج الغذاء والكرامة.
في إطار سعينا لفهم أسباب غياب السيادة الغذائية، نجد أنفسنا أمام مشهد مؤسف يتقاطع فيه التلوث الصناعي الناتج عن “المجمع الكيميائي” وهو منظومة متكاملة من المصانع التي تسببت، على مدى أكثر من خمسين عاما في تلويث التربة والهواء والمياه من جهة، مع سياسات ممنهجة اتبعتها السلطة من جهة أخرى، تُقيد حرية الفلاحين وتُخضعهم لمنظومة إنتاج يتحكم فيها كبار الفاعلين في الأرض وقطاعات الأدوية والأسمدة والبذور.
وسط هذا الواقع القاتم، تنهض كابانا كمقاومة حيّة، تُجسد صمود الفلاحين الصغار وتشبّثهم بحقهم في إنتاج غذائهم. إنها تقف في وجه منطق السوق وتستمر في عنادها ومقاومتها لاثنين المُجمع والسُلطة، رافضة أن تُدفن تحت أنقاض هذا التلوث، مُؤكدة أن الزراعة يمكن أن تكون أداة تحرر لا وسيلة تبعية.
كابانا هي امتداد لمدينة غنوش التي أفرغت من ثرواتها البحرية فما كان لها إلا لتثأر وتشرع في استصلاح أرضها مادام البحر قد جرّد من ثروته، بعد أن كان في السابق أكبر وأهم المحاضن في المتوسط باستقباله لعديد الأنواع من الأسماك (تصل إلى 300 نوع)، ومنذ التسعينيات ومع تزايد التلوث تراجعت أعداد الأسماك القادمة الى خليج قابس بشكل كبير ودُمرت الثروة السمكية، وبالتالي بدأ التوجه نحو خلق بدائل ومنوال إنتاج جديد في المنطقة، ولعل الزراعة والنشاط الفلاحي كان المجال الأقرب.
زيارة غنوش أتاحت لنا فهم ثنائية النشاط الفلاحي والصيد البحري والوقوف على بروتريهات فلاحين وفلاحات غنوش العاملين والعاملات في ما تبقى من الإنتاج البحري (عقرب البحر أو كما يطلقون عليها تسمية داعشCrabe ) وكذلك في استصلاح الأرض وزرعها. عندما توجهنا إلى هناك في زيارتنا الميدانية ضمن مدرسة شبكة سيادة وتحديدًا إلى كابانا التابعة لمنطقة العوينات 1 والعوينات 2 من معتمدية غنوش، كنا محظوظين جدًا لتزامن تواجدنا في هذه المنطقة مع إيقاف الغازات المنبعثة من المُجمع الكيميائي لمدة أسبوع أو أكثر للصيانة والتي عانى ويعاني منها سكان شط السلام وغنوش وبوشمة منذ زمن بعيد، وكذلك الحال لباقي معتمديات ولاية قابس التونسية ولكن بدرجة أقل.
الزيارة الميدانية التي قمنا بها للمنطقة، مؤخرا، فتحت أمامنا فكرة نقل ما لاحظناه في الميدان وتوثيقه، وبذلك تقرر الاستناد إلى المنهج الاثنوغرافي الكيفي بتقنياته المختلفة (الملاحظة المباشرة أو الميدانية، المقابلة نصف الموجهة، الصور..). يسهل لنا هذا المنهج الذي يقوم على الوصف وتحديد سمات المجتمع أو الجماعة المدروسة[1]، وتقديم تلخيص شامل لها.
كان الدافع الأساسي لهذه الزيارة هو إسناد الفلاحين\ات الصغار في المنطقة والوقوف إلى جانبهم، الاستماع لهم والتفكير معهم وقد جرى استضافة جميع المنظمين للمدرسة الصيفية من شبكة سيادة والمشاركات والمشاركين من فلاحات وفلاحين وباحثات وباحثين من قِبل فلاح استصلح أرضه وهو اليوم ينتج بمردود جيد ويُوجّه جزءًا كبيرًا من إنتاجه للخضروات نحو السوق، يُدعى عم الهادي.
لعم الهادي تجربة كبيرة في المنطقة اذ كان يعمل في أراضي أخرى منذ صغره وعمل مع والده لتبدأ بذلك اهتماماته الأولى بعالم الفلاحة والأرض. في سنة 2013 استطاع توفير هذه القطعة من الأرض وأصبح يعمل من أجل تحقيق غذاء عائلته وتحقيق متطلبات حياته اليومية.
كان لهذه الزيارة أهمية كبيرة، منها معرفة المنطقة والوقوف على التقنيات المعتمدة الزراعات والغراسات المهيمنة والتي يولي لها أغلب فلاحي المنطقة اهتمامهم، والاطلاع على المشاكل والصعوبات التي يواجهونها.
تستمر كابانا في إنتاجها بفضل إصرار فلاحيها وصمودهم رغم ما حدث من منع ورفض من السلطة وصلت حد الإيقاف والسجن. فالاهتمام بالأرض والتنشئة في بيئة فلاحية تُلخص عالم هؤلاء، فالأرض ليست منّة (صدقة) عليهم من أحد بل هي حقهم الطبيعي بما أنهم عرفوا كيف يقوموا بتغييرها واستصلاحها بعد أن كانت مهملة.
اثنوغرافيا كابانا:
بعض الأمتار التي تفصل هذه الأراضي الممتدة والمقاطع الفلاحية المصنفة ضمن الأراضي الدولية في الجهة الغربية من شاطئ غنوش المنهك منذ سنوات من التلوث الذي يُخلفه المُجمع الكيميائي، هذه السلسلة من الأراضي المُتاخمة للشاطىء كانت في زمن مضى مجموعة من السباخ غير المُنفصلة، تحتوي بداخلها على النباتات الملحية Halophytes مثل (القصباي، الحماضة…).
في السابق، كانت هذه المنطقة تتجمع فيها المياه الراكدة وتكثُر فيها الحشرات وغيرها من النباتات الطُفيلية. ومع بداية التسعينيات من القرن الماضي، قرر فلاحو \ات غنوش استغلال هذه الأراضي نظرًا للزحف العمراني الذي شهدته منطقة غنوش وعدم وفرة الأراضي الصالحة للزراعة والنشاط الفلاحي.
وبما أن هذه المنطقة المستغلة كانت مهملة في السابق ماعدا بعض الأنشطة الترفيهية مثل الصيد الذي يمارسه السياح وتحديدًا اصطياد الخنازير بإشراف السلطة آنذاك، كان للفلاحين هنا رأي آخر وهو أن من الأفضل استغلالها لمهام إنتاجية. ومنذ تلك الفترة بدأ استصلاح هذه الأرض فعليًا وتحويلها شيئًا فشيئا إلى أراضي منتجة.
أصبحت كابانا اليوم، بفضل المجهودات التي يقوم بها فلاحو\ات المنطقة، أراضي مُنتجة للغذاء والطعام. أكثر من 900 فلاح كما جاء على لسان عم الهادي، يزرعون مساحة تفوق 1500 هكتار، تتضمن هذه المساحة مجموعة من المقاسم مقسمة بين الهكتار والهكتارين والثلاثة هكتارات أو أربعة كأقصى تقدير، لكل عائلة الحق في الانتفاع بهذه الأرض وتحديدًا أبناء المنطقة الذين يعانون من عسر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية (بطالة، نسب فقر عالية ،تهميش…) لذلك توجهت عائلة الرحايمة (نسبة إلى لقب رحيمي) والعلاية (نسبة إلى لقب علية) إلى هذه المنطقة وافتكوا هذه الأراضي لاستصلاحها ومن ثم غراستها وزرعها كما فسر لنا بعض الفلاحة هناك، واقتسامها فيما بينهم بطريقة منظمة جرى الاتفاق عليها جماعيًا.
بعد الانتهاء من التقسيم وتحضير الأرض انطلق الفلاحون في حفر آبار سطحية بطرق وتقنيات تقليدية، تستغرق هذه العملية مدة أسبوعين على الأقل. في هذه المرحلة أي في بداية تحضير الأرض والشروع في تهيئتها واجه فلاحو\ات كابانا الإيقافات والتهديد بالسجن إلا أنهم واصلو إصرارهم وتشبثهم بحقهم في انتاج غذائهم.
لم تستمر العملية طويلًا لإنتاج الطعام والغذاء، فتقسيم الأرض وحفر الآبار وبداية حرثها بعد تهيئتها لا يتجاوز الشهرين أو الثلاثة أشهر كأقصى تقدير. يعود كل هذا إلى الاستناد لبعض الخبرات المكتسبة من الأجداد وكذلك الحاجة الملحة إلى العيش بكرامة. فقد كان الدافع الأساسي للفلاحين\ات هو خلق أسلوب إنتاج خاص.
تعتمد “كابانا” على أسلوب إنتاج الغذاء محليًا، حيث تلعب العائلة دورًا محوريًا من خلال تقسيم العمل بين جميع أفرادها. ويعود اختيار هذا النمط من الإنتاج إلى خصوصية المنطقة، إذ كانت في الماضي القريب، تتميز بكثافة النشاط الفلاحي “الواحة كمثال”. أما اليوم، فقد أدى تدهور البيئة، وخصوصًا تضرر الطبقات الأرضية، إلى تراجع هذا النشاط ليصبح هامشيًا وضعيفًا.
كما أن جزءًا كبيرًا من الشريط الساحلي قد تعرض لأضرار بيئية جسيمة نتيجة التلوث، وهي أزمة أثّرت على كامل أراضي ولاية قابس. اعتمدت كابانا تقنياتها وأدواتها التقليدية البسيطة ورغم ذلك، فهي ناجعة وأثبتت فعاليتها وجدواها في تأمين قوت العيش لعدد كبير من العائلات، وفي تحقيق إنتاج فعلي للغذاء. ويعود ذلك إلى الإصرار الكبير والجهود المبذولة في استصلاح أراضٍ كانت تُعتبر سابقًا غير صالحة للزراعة، وإعادة إحياء النشاط الزراعي فيها.
يتطلب استصلاح الأرض عديد التقنيات وللوصول إلى مرحلة الزراعة والإنتاج وجب المرور عبر مراحل تتطلب صبرًا كبيرًا وجهودًا مضاعفة. في البداية، إفراغها من المياه الراكدة هناك ومن ثم انتظار أن تنحسر المياه وتجف التربة، وعندما تجف وتظهر تلك الطبقة من الملوحة البيضاء على الأرض يتم تحريكها وحرثها بحذر. في العادة، يتم استعمال محراث تقليدي أو آلة عصرية صغيرة الحجم وذلك لصعوبة استعمال الجرار خوفًا من الانزلاق أو الإضرار بالأرض. بعد الانتهاء من هذه العملية الشاقة يجري إضافة تربة أخرى، تُجلب في أغلب الأحيان من مناطق بعيدة، ودمجها بالتربة الأصلية لتقوية الأرض.
عند إنجاز المراحل التي ذكرناها يشرع فلاحو\ات المنطقة في مرحلة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، حيث يقام حول كل مقطع ستجري زراعته “خندق”، كما يسميه السكان المحليون، يمتص الأملاح والمياه الزائد. وهكذا يحمي الفلاحون\ات المنتوج من التلف فتستقر المياه في ذلك الخندق إلى أن تأخذ مساراتها أو أن تجف وحدها.
الزراعة كفعل مقاوم:
تعاني كابانا من التهميش والإهمال، ومن السياسات التي كانت ومازالت تنتهجها الدولة منذ زمن بعيد، ومن المؤسف أن نرى هدر كل هذه الجهود والتضحيات الكبرى وعدم استثمارها أو البناء عليها من المؤسسات الرسمية التابعة للدولة. تتعرض كبانا دائما إلى الرفض والمواجهة من هذه المؤسسات، مما نتج عنه معاناة الفلاحين ومحاولة ثنيهم عن العمل والإنتاج هناك.
كابانا أو أرض الفلاحين الذين لا يملكون أرضًا قاومت شرور اثنين: المُجمع الذي ينتهك طبقات الأرض بالإشعاعات التي يطلقها والهواء الملوث منذ نصف قرن، والوصم الذي تصر السلطة على إلحاقه بهم، فهي تطلق على فلاحي\ات هذه المنطقة صفة غريبة نوعا ما وهي “مغتصبو الأرض” ولا تتوقف عن ملاحقتهم\هن.
إن المتمعن في طريقة استصلاح الأرض سيجد حرفة وإتقان كبير وهو يراقب ذلك الذكاء المنبثق من خصوصية المنطقة، يقول الماركسي ليون تروتسكي في كتاب الأدب والثورة أن “كل طبقة سائدة تبدع ثقافتها وفنها” وهنا يبدو أنه من البديهي أن تبدع الطبقات الأخرى (البروليتاريا) بدورها ثقافتها وفنها الخاص.
يمكن أن نطبق هذا المثال بحذر على التقنيات التي ينتجها عم الهادي وبقية فلاحي المنطقة في أرضهم. فغياب التشجيع من قِبل السلطة والمطاردة والتهديد بالطرد من هذه الأرض ساهم في خلق ثقافة مقاومة وكذلك استنباط طرقهم الخاصة للإنتاج وبالتالي إحراج السلطة.
كابانا هي درس في الجغرافيا المنسيّة والمُطاردة من قِبل السلطة، أرض نهضت في ظل نظام استبدادي ومازلت تشق طريقها نحو كسب حرية الفلاحين\ات وحق تصرفهم في الأرض، هي كغيرها من الدروس التي وجب استخلاصها وخاصة فهمها، يلخص عم الهادي علاقته بهذه الأرض في كلمة “إنها الحياة”:
- “لو فرضنا أنهم قدموا إلى هنا لإخراجك بالقوة العامة؟”
- “حينها سأكون قد متُ، وبدلًا من الخروج سأوصي بدفني في هذه الأرض”.[2]
يذكرنا عم الهادي بالسيركونسيليون les circoncellions وهي جماعة فلاحية متمردة في شمال أفريقيا خلال العهد الروماني[3] الذين كانوا وقفوا في وجه الملوك الرومان، أما فلاحو العوينات وكابانا، وخصوصا عم الهادي، فيدافعون عن أرضهم ضد زحف التلوث، وضد المراقبة التي تمارسها السلطة منذ سنوات ولو كلفهم ذلك حياتهم، كتعبير عن تجذر الأرض داخلهم وارتباطهم الغريزي بها. فعلى النقيض من حركة السيركونسيليون، الذين يتجسّد إيمانهم في الخلاص والحياة الأخرى، لا يرى عمّ الهادي الخلاص إلا كشأن دنيوي في أرضه، تلك الأرض التي يزرعها ويسعى لأن يحافظ عليها رغم ما واجهه من متاعب.
- مالك الزغدودي وياسين لعبيدي
[1] اثنولوجيا أنثروبولوجيا، فيليب لابورت، جان بيار فارنييه، ترجمة د.مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ص52.
[2] حوار مع عم الهادي
[3] الدوارون أو السيركونسيليون بالفرنسية les circoncellions هم مجموعة من الفلاحين والمتمردين الذين ظهروا في الفترة الرومانية في شمال افريقيا حوالي القرن الرابع ميلادي.